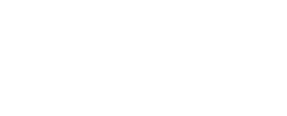تحلّ في الخامس من يونيو ذكرى رحيل واحد من أعظم شعراء مصر والعالم العربي، الشاعر الرقيق أحمد رامي، الذي وُلد في 9 أغسطس عام 1892، ورحل عن عالمنا بعد أن نقش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الأدب والموسيقى العربية.
وُلد رامي في بيت والده الدكتور محمد رامي بحي الناصرية في القاهرة، في أجواء مفعمة بالفن والطرب، حيث اعتاد البيت أن يكون صالوناً فنياً لا يخلو من مغنٍ أو عازف، وكأن الطبيعة تؤهله لما خلق له، وقد كانت لتلك النشأة الفنية أثر عميق في تشكيل وجدانه الشعري المبكر.
اصطحبه والده عام 1899 إلى جزيرة طاشيوز الساحرة، حيث انطبعت في ذاكرته مشاهد الجمال الطبيعي التي غذّت خياله الشعري لاحقًا.
عاد إلى مصر عام 1901، وعهد به والده إلى عمته بسبب كثرة أسفاره، فألحقته بالكتاب والمدارس، ليستعيد لغته العربية بعد أن بدأ في التحدث بالتركية واليونانية. تنقّل رامي بين عدد من الأحياء والمدارس، إلى أن حصل على الشهادة الابتدائية عام 1907، ثم البكالوريا من المدرسة الخديوية عام 1911، والتحق بعدها بمدرسة الرعيل الأول من الأدباء “مدرسة المعلمين العليا”.
في حي بركة الفيل، حيث أقامت والدته بعد استقرارها بمصر، عاش رامي أجواء صوفية أثرت روحه، كما تعرف في تلك الفترة على أعلام الشعر والأدب كحافظ إبراهيم، وعبد الحليم المصري، وإسماعيل صبري الذي كان يعقد ندوة أدبية ببيته أدخلت رامي عالم الأدباء وعرفته بهم.
صدر له الجزء الأول من ديوانه الشعري، وقدم له الشاعر خليل مطران، ثم سافر إلى باريس عام 1922 ضمن بعثة علمية، وعاد إلى مصر عام 1924. في العام نفسه، التقى بالسيدة أم كلثوم، وكان اللقاء الأول بقصيدته الشهيرة “الصب تفضحه عيونه”، من ألحان الشيخ أبو العلا محمد. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أم كلثوم إلهامه الأكبر، تفجّر معها في داخله نبع جديد من المعاني والمشاعر، حتى اعترف بذلك في أبياته الشهيرة:
“صوتك هاج الشجو في مسمعي
وأرسل المكنون من أدمعي
سمعته فانساب في خاطري
للشعر عين ثرَّةُ المنبع”
بعد تخرجه، التحق بوظيفة في دار الكتب المصرية، وكان يحمل ثلاث شهادات عالية ويجيد الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، إلى جانب العربية، ويفهم التركية. أبدع في تطوير نظام الفهرسة هناك بما عُرف بأسلوب “word tatch” أو مفتاح الكتاب، واشتهر بـ”فهرس رامي”. وكان من أهم إنجازاته مشاركته في تحقيق وإخراج “قاموس البلاد المصرية من أيام الفراعنة إلى اليوم”.
عاصر رامي جميع مدارس الشعر العربي الحديث، فنهل من معين المدرسة الكلاسيكية التي أعادت الشعر إلى صيغته الأصيلة، وتأثر بروادها من أمثال شوقي وحافظ إبراهيم، ثم انفتح على مدرسة الديوان التي ركزت على الوجدان والتجربة الذاتية، وشعراء مثل العقاد والمازني وعبدالرحمن شكري، الرومانسية التي تمردت على النمطية وفتحت أبواب الشعر على مشاعر الذات وأسرارها بشعراء مثل علي محمود طه، إبراهيم ناجي، وأبو القاسم الشَّابِّي، وصولًا إلى أدب المهجر المتسم بالحنين والاغتراب.ومن روادها جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي.
كان رامي بلبل جيله الصداح، أغلب شعره من الأبحر القصيرة، وكان ديوانه ديوان حب وألم متفرد بشخصيته فيه فلا يتسلق على كلام غيره.
كان شعره وحيًا يلقى في روعه، لا تكلُّف فيه ولا تصنُّع، لا يتكلفه بل ينساب منه انسياب الماء العذب، ويغلب على شعره الحب هاديء والحزن الناعم. صدرت له عدة دواوين منها:
ديوانه الأول (1917)، ديوانه الثاني (1920)، ولعلّ من أعظم أعماله الأدبية والفكرية ترجمته الخالدة لرباعيات الخيام عن الفارسية، حيث ألبسها حُلّة عربية لا تقل بهاء عن أصلها رباعيات الخيام (1924)، ديوانه الثالث (1925)، النسر الصغير (1927)، غرام الشعراء (1934)، جمع دواوينه الثلاثة في ديوان واحد باسم “ديوان رامي” (1947).
ترجل رامي من مملكة الفصحى التي تربّع على عرشها ملكًا متوَّجًا في القصيدة العاطفية، ليصوغ عامية جديدة شديدة الخصوصية تحمل بصمته، جديدة في معانيها ومفرداتها ومستواها الذي اقترب من الفصحى، مما أسهم بشكل جوهري في النهضة التي شهدتها الأغنية العربية في العصر الحديث، وهو الذي أنقذ الغناء المصري من الابتذال.
أسهم رامي في إثراء المسرح والغناء والسينما، فكتب نحو 250 قصيدة غنائية، و15 مسرحية مترجمة عن الأدب الإنجليزي، و35 قصة سينمائية، وشارك في كتابة حوارات وأغاني لأكثر من 30 فيلمًا، منها “وداد” و”دنانير” لأم كلثوم.
نال رامي جائزة الدولة التقديرية، ووسام الفنون والعلوم، والدكتوراه الفخرية، تقديرًا لعطائه الكبير. ومع وفاة أم كلثوم، خفت صوته واعتزل الحياة، وكتب في رثائها:
ما جال في خاطري أنّي سأرثيها
بعد الذي صُغتُ من أشجى أغانيها
قد كنتُ أسمعها تشدو فتُطربني
واليومَ أسمعني أبكي وأبكيها
اعتزل رامي الكتابة وساءت حالته الصحية، حتى وافته المنية في 5 يونيو 1981، تاركاً تراثاً شعريًا وفنيًا يظلّ أحد أهم أعمدة الثقافة العربية الحديثة، وإحدى ركائز القوة الناعمة لمصر.
المصدر: أ ش أ